

محي الدين زنگنه الجبل الذي تفيَّأنا بظلاله الوارفة
هو الذي رأى كل شيء فتغني بذكره يا بلادي
ملحمة گلگامش
گلگامش..ذلك الشقي المغامر المعذب بسر الخلود عاد بعد رحلة عناء وشقاء طويلة إلى (أوروك) خائبا خاسراً، ومحطم الفؤاد. عشبة الخلود التي سعى إليها قاطعا الفيافي، والقفار، والصحارى سرقتها أفعى النهر في غفلة منه فعاد بخفي حنين. وفي أوروك ذات الأسوار اهتدى إلى الجوهر الحقيقي لذلك السر فحقق للناس ما جعله خالدا على مر الأزمان.
من ذ لك السر انطلقت كتابات محي الدين زنگنه فكانت قريبة من الناس ومعاناتهم، ومن
الفقراء وهمومهم، ومن الأطفال وتطلعاتهم، ومن المرأة ومكابداتها، ومن الشباب
وجموحهم نحو عالم لا تسلب فيه الحريات، ولا يستَغِلُ فيه الإنسانُ أخاه الإنسان.
منذ أول أعماله المنشورة لفت انتباه الجميع: نقاداً، وقراء، وباحثين. رسخت صورة
كتاباته في أذهانهم وستظل راسخة ـ في اعتقادي ـ إلى زمن لا أحد يستطيع تحديده
بالضبط فكتاباته في بلادي كما هي كتابات شكسبير في بلاده. كثيرة، وغزيرة، وعميقة في
التصاقها مع تراجيديا الواقع المعيش.
لك السر انطلقت كتابات محي الدين زنگنه فكانت قريبة من الناس ومعاناتهم، ومن
الفقراء وهمومهم، ومن الأطفال وتطلعاتهم، ومن المرأة ومكابداتها، ومن الشباب
وجموحهم نحو عالم لا تسلب فيه الحريات، ولا يستَغِلُ فيه الإنسانُ أخاه الإنسان.
منذ أول أعماله المنشورة لفت انتباه الجميع: نقاداً، وقراء، وباحثين. رسخت صورة
كتاباته في أذهانهم وستظل راسخة ـ في اعتقادي ـ إلى زمن لا أحد يستطيع تحديده
بالضبط فكتاباته في بلادي كما هي كتابات شكسبير في بلاده. كثيرة، وغزيرة، وعميقة في
التصاقها مع تراجيديا الواقع المعيش.
جمعتني به، وبالناقد العراقي الكبير ياسين النصير جلسة بعقوبية فريدة وكنت قد
انتهيت من كتابة مسرحيتي الأولى (زمرة الاقتحام) وسلمت مخطوطتها له بتواضع جم
فاحتفى بها أشد الاحتفاء لكنه في الوقت ذاته اعتذر أشد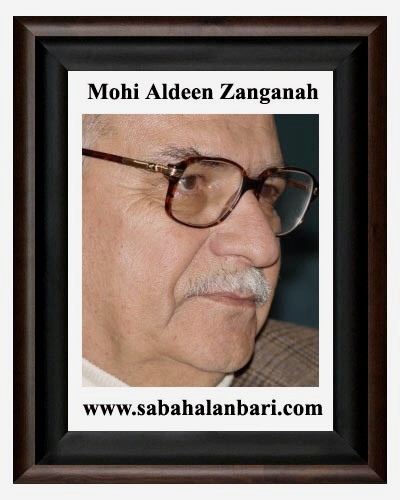 الاعتذار عن الكتابة عنها لا
لشيء إلا لكونه بطلها المحوري.
الاعتذار عن الكتابة عنها لا
لشيء إلا لكونه بطلها المحوري.
لم تكن تلك الجلسة الثلاثية إلا فرصة سانحة كي يطلب من صديقه النصير ما لم يطلبه من أحد لا من قبل ولا من بعد. أتذكر انه قدمني له قائلاً بصوت وقور:
دعني أقدم لك "صباح" الذي لفت انتباهي مذ كان واحدا من طلبتي في مرحلة الدراسة الاعداية بأسئلة لم تخطر على بال أحد من مجايليه بل أنها لن تخطر على بالهم أبداً، وتنبأت منذاك أن طاقته الكامنة لا بد أن تتفتق يوما ما عن موهبة جديرة بالاهتمام. وهذه هي أول بادرة لنبوءتي.
سلمه مخطوطة النص، وقال له: أريدك أن تهتم بصباح كما لو انك تهتم بولدي الوحيد ثم سلمه نص مسرحيتي (زمرة الاقتحام).. طوى الضيف الصفحة الأولى، وقرأ في الصفحة الثانية بصوت مسموع: المكان والزمان: بعقوبة عام 2552 صمت كما لو انه يتأمل شيئا ما ثم نظر إلي نظرة أحسست أنها اخترقتني، وبهدوء قال: من أي المواليد أنت؟ قلت من مواليد عام 1952 قال قد عرفت هذا..انك تلعب بمواليدك في هذه المسرحية مرة تستخدمها كما هي (52) ومرة تقلبها (25) ومن تكرار هذه الأرقام وقلبها جاء تحديدك للزمان. دهشت لهذا الاستنتاج السريع الذي ما كان يخطر على بالي على الرغم من أنني أنا الذي وضعته أسفل عنونة المسرحية. وتساءلت في سري إذا كان الناقد قد اكتشف منذ اللحظة الأولى سر الزمن فما بالك وهو يغور مرتحلا في مطبات النص وخفاياه! كنت متلهفا لمعرفة ما ستخطه أنامله على حاشية المسرحية، وازددت تلهفا لقراءة ما كتبه عنها في مجلة (الطليعة الأدبية) وكم كان مؤسفا خبر تقليص عدد المجلات التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد وكانت أول المجلات المشمولة بالتقليص مجلة (الطليعة الأدبية). بعد مدة غير قصيرة ذهبت إلى مقر المجلة وبحثت مع من كان رئيساً لتحريرها عما كتبه النصير عن مسرحيتي الأولى ولكن جهودنا باءت بالفشل الذريع. وفي عام 1993 عندما دعت مجلة الأقلام العراقية إلى مسابقة للنص المسرحي العراقي قدمتها لهيئة المسابقة فحازت على الجائزة الأولى.
حين سلمته مخطوطة ذلك النص أثناء جلوسنا في مشغل التصوير الذي كنت أديره في بعقوبة لم يظهر على ملامحه أي شيء غريب. كنت أتوقع منه تعليقا ما. دهشة ما خاصة وهو نصي المسرحي الأول. ودعني مغادرا إلى بيته في صوب بعقوبة الآخر. في اليوم الثاني كرر زيارته لي وراح يسرد علي ما حدث بعيد مغادرته مشغلي في اليوم الفائت قائلاً:
عندما جلست في المركبة التي تقلني إلى البيت فتحت النص، وبدأت بقراءته فشدتني أحداثه منذ السطر الأول، وعندما وصلت إلى موضوعة اختيار كاتب من بعقوبة كي يمرر (المخترع) من خلاله مخططاً لاحتلال المدينة قلت في سري لا بد أن صباح سيختارني أنا. وعندما تقدمت بالقراءة وجدتني واحدا من شخوصها بل بطلا محوريا لإحداثها.
كان زنگنه ي عرف تماما ما أكنه من محبة أزلية له كشخصية لها ما يميزها عمن عرفتهم
في حياتي، وكان يعرف أنني معجب بصفاته النادرة، ولا غرابة في اختياري له بطلا
لمسرحيتي التي أكدت فيها انه أسطوري في قوته الفكرية، وفولاذي في صموده أمام سطوة
(المخترع) وأساليب التعذيب التي مارسها بنذالة وانحطاط ضد ارادته التي لا تلين،
وعلى عمق العلاقة التي بيننا وإنسانيتها. نقل لي القاص الكبير جهاد مجيد ـ وكان
واحدا من محرري المجلة ـ عن رئيس التحرير زعمه أن هذه المسرحية من تأليف زنگنه وأن
زنگنه أخفى اسمه عنها بدافع الخجل من طرح شخصيته فيها بشكل صريح. وما كان من جهاد
إلا أن أكد معرفته التفصيلية، وعمق العلاقة التي تربط بيني وبين زنگنه. هذا الكلام
وعلى الرغم من تضمنه على تهمة لا أحبها دعم ثقتي من أن المستوى الذي حققته المسرحية
كان كبيرا بما يكفي للشك في أنها واحدة من أعمال زنگنه الكبيرة. السؤال المهم هنا
هل قلَّدت زنگنه وأنا اكتب هذه المسرحية، وهل أردت أن أكون شبيها له فعلاً؟ لنقرأ
هذا المختطف من صحيفة (الثورة) البغدادية المنشور بتاريخ 6 /2 / 1994 وهو أول
حوار صحفي تجريه معي صحيفة رسمية وجاء فيه ما يأتي:
عرف تماما ما أكنه من محبة أزلية له كشخصية لها ما يميزها عمن عرفتهم
في حياتي، وكان يعرف أنني معجب بصفاته النادرة، ولا غرابة في اختياري له بطلا
لمسرحيتي التي أكدت فيها انه أسطوري في قوته الفكرية، وفولاذي في صموده أمام سطوة
(المخترع) وأساليب التعذيب التي مارسها بنذالة وانحطاط ضد ارادته التي لا تلين،
وعلى عمق العلاقة التي بيننا وإنسانيتها. نقل لي القاص الكبير جهاد مجيد ـ وكان
واحدا من محرري المجلة ـ عن رئيس التحرير زعمه أن هذه المسرحية من تأليف زنگنه وأن
زنگنه أخفى اسمه عنها بدافع الخجل من طرح شخصيته فيها بشكل صريح. وما كان من جهاد
إلا أن أكد معرفته التفصيلية، وعمق العلاقة التي تربط بيني وبين زنگنه. هذا الكلام
وعلى الرغم من تضمنه على تهمة لا أحبها دعم ثقتي من أن المستوى الذي حققته المسرحية
كان كبيرا بما يكفي للشك في أنها واحدة من أعمال زنگنه الكبيرة. السؤال المهم هنا
هل قلَّدت زنگنه وأنا اكتب هذه المسرحية، وهل أردت أن أكون شبيها له فعلاً؟ لنقرأ
هذا المختطف من صحيفة (الثورة) البغدادية المنشور بتاريخ 6 /2 / 1994 وهو أول
حوار صحفي تجريه معي صحيفة رسمية وجاء فيه ما يأتي:
[على الرغم من تأكيدك المستمر على أهمية دور الكاتب المسرحي المعروف محي الدين زنگنه إلا أن نهجك في الكتابة المسرحية يختلف عنه..فأين نقاط الاشتراك بينكما وأين نقاط الاختلاف؟
ـ دعني أخبرك أولا ـ لو سمحت ـ أنني وضعت مؤلفا نقديا تناولت فيه بالدراسة والتحليل أدب محي الدين زنگنه ولكني نظرا لظروف الطبع القاهرة لم استطع إصداره بعد. وتركت أمره إلى اتحاد الأدباء الذي وعد بطبع ست مخطوطات لمحافظتنا آمل أن يكون "السهل والجبل" واحدا منها. لقد تكشفت لي ـ بعد هذه الدراسة ـ عوالم محي الدين زنگنه الجميلة فانبهرت بها، واستمتعت بأجوائها، وأطلت التأمل في تفاصيلها حتى قدحت في ذهني فكرة تمجيد هذا الكاتب المسرحي بنص مسرحي فكتبت (زمرة الاقتحام) ولكنني كتلميذ طموح، ومجد من تلاميذ زنگنه الأستاذ والصديق سعيت دوما إلى أن يكون لي أسلوبي الخاص، وطريقتي المتفردة في الكتابة، وان لا أكون نسخة أخرى لهذا الفنان الكبير.. سعيت إلى كينونة أخرى تميزني وتمنحني:
أولا ـ الحصانة ضد الامتزاج والانصهار في بوتقته ككاتب.
ثانيا ـ إمكانية اللحاق به ومن ثم تجاوزه كلما سنحت لي فرصة تجاوزه...
وهنا أود أن أريحك أكثر فأقول أنني سعيت إلى أن أكون شبيها لمحي الدين زنگنه في كل شيء إلا في الكتابة. هذه هي حدود التشابه والاختلاف بيننا على الرغم من إقراري السابق بأستاذيته.]
عندما نشر هذا الحوار في الصحيفة إبان مهرجان بغداد الرابع للمسرح العربي قرأه زنگنه بإمعان، وعندما التقينا في أروقة المهرجان قال بتأكيد كبير: "سأعتبر كلامك هذا عهدا قطعته على نفسك" قلت والخجل باسطا نفوذه علي من الجبل الذي يقف أمامي شاهقاً: نعم. ولم استطع إضافة أي كلمة أخرى.
علاقتي بزنگنه إذن تعود إلى تلك الأيام من الدراسة الإعدادية يوم كان الشعر شاغلي
الكبير الذي تر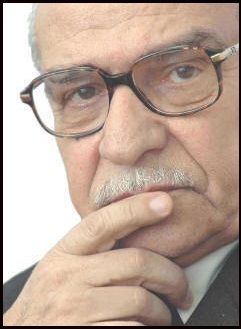 اجع بوقار أمام جنوني المسرحي، ومحبتي للخشبة التي سكنتني ولم استطع
التخلص من سحرها الدرامي. منذ ذلك الوقت لم يكتب زنگنه مسرحية أو قصة أو رواية إلا
وكنت قارئها الأول. ولم يمنحني فرصة لامتداح أي منها لأنه كان يريد أن يسمع مني ما
لم يستطع الآخرون البوح به وجهاً لوجه إذ لم يكن في مدينتنا من هو قادر على تجاوز
ضعفه وخجله أمام القامة السامقة، أمام محي الدين زنگنه. وكان علي أن أدرب نفسي على
شيء من الوقاحة كي أتسلح بها أمام خجلي البريء من الجبل الذي لم يسبق لأحد أن تصدى
لقمته الشاهقة. كتبت متجاوزا خجلي أول مقالة عنه عام 1993 وساهمت بها في جلسة اتحاد
الأدباء التي ضمت كلا من الناقدة المعروفة بمواقفها النقدية السديدة نازك الأعرجي،
والناقد الموسوعي باسم عبد الحميد حمودي، والناقد الشمولي سليمان البكري، وأنا. كنت
قد اخترت عنونتها من وحي شخصية زنگنه الفريدة وكتابته المتفردة (هذا هو محي الدين
زنگنه) حين سردت ما جاء فيها أمام الحضور لم أكن أتوقع أنها ستكون مثار إعجاب بعض
الأخوة من محبي النقد والأدب، وعندما أرسلتها إلى صحيفة (العراق) ونشرت على صفحتها
الأدبية
بتاريخ 21/ 7/ 1993 صارت مثار حديث أصدقائنا في الجلسات الليلية التي كانت
شائعة بيننا وقتذاك.
اجع بوقار أمام جنوني المسرحي، ومحبتي للخشبة التي سكنتني ولم استطع
التخلص من سحرها الدرامي. منذ ذلك الوقت لم يكتب زنگنه مسرحية أو قصة أو رواية إلا
وكنت قارئها الأول. ولم يمنحني فرصة لامتداح أي منها لأنه كان يريد أن يسمع مني ما
لم يستطع الآخرون البوح به وجهاً لوجه إذ لم يكن في مدينتنا من هو قادر على تجاوز
ضعفه وخجله أمام القامة السامقة، أمام محي الدين زنگنه. وكان علي أن أدرب نفسي على
شيء من الوقاحة كي أتسلح بها أمام خجلي البريء من الجبل الذي لم يسبق لأحد أن تصدى
لقمته الشاهقة. كتبت متجاوزا خجلي أول مقالة عنه عام 1993 وساهمت بها في جلسة اتحاد
الأدباء التي ضمت كلا من الناقدة المعروفة بمواقفها النقدية السديدة نازك الأعرجي،
والناقد الموسوعي باسم عبد الحميد حمودي، والناقد الشمولي سليمان البكري، وأنا. كنت
قد اخترت عنونتها من وحي شخصية زنگنه الفريدة وكتابته المتفردة (هذا هو محي الدين
زنگنه) حين سردت ما جاء فيها أمام الحضور لم أكن أتوقع أنها ستكون مثار إعجاب بعض
الأخوة من محبي النقد والأدب، وعندما أرسلتها إلى صحيفة (العراق) ونشرت على صفحتها
الأدبية
بتاريخ 21/ 7/ 1993 صارت مثار حديث أصدقائنا في الجلسات الليلية التي كانت
شائعة بيننا وقتذاك.
لم تكن هذه المقالة هي الأولى التي نشرت لي في صحيفة رسمية لأنني سبقتها بمقالة عن شعر الستينات كنت قد نشرتها في العدد الخامس من مجلة(الثقافة) الصادرة في حزيران 1971 يوم كان يرأس تحريرها الدكتور صلاح خالص والتي قررت بعدها التوقف عن الكتابة إلى اجل غير مسمى لأسباب كنت احتفظ بها لنفسي على الرغم من تأكيد د.سعاد محمد خضر (سكرتيرة التحرير) على ضرورة الاستمرار وهذا هو ما نقله إلي بالضبط الأستاذ عبد الرحمن البكري.
عندما جمعتني بزنگنه جلسة من جلساتنا المستمرة في بيته الكائن في بعقوبة الجديدة قلت له: هل كانت المقالة بالمستوى المطلوب. ابتسم قليلا وبهدوء قال: ألم تكن صالحة للنشر؟ قلت هي كذلك ولكنني اسأل زنگنه ـ وهذه هي المرة الأولى التي تجرأت فيها فنحيت الكلفة بيننا ـ عن صلاحيتها. قال لا خوف عليك الآن يا صباح. أرى أن لك قدرات لا بأس بها في الكتابة، ولم يحدثني عن المقالة وما جاء فيها لا لشيء إلا لأنه لا يحب الحديث عن نفسه أبداً. وعندما ألححت عليه قال أنت اعرف مني بما كتبت. هو هكذا دوما لا يحب الحديث عن نفسه أو عن نصوصه لاعتقاده أن النص الجيد هو الذي يتحدث عن نفسه بنفسه وانه لا يملك قولا أكثر مما قاله في نصه الفلاني وهو لهذا ولغيره لم يكن يرغب بأي حوار أو لقاء صحفي، وعندما انتهيت من (الببليوغرافيا) التي أعددتها بصبر أيوبي (حسب وصفه) عن كل صغيرة وكبيرة نشرت له هنا وهناك وجدت أن اللقاءات لم تدخل مفردات حياته الإبداعية. خرجت من بيته وأنا أغبط نفسي على ما سمعت منه ولم أكن اعرف في البدء ما الذي حببني إليه فاختارني كواحد من أصدقائه المقربين القلائل على الرغم من الاثني عشرة عاما التي تفصل بين عمرينا وجيلينا فمعيار الصداقة عنده يرتبط بالأفكار ويساريتها، وبالثقافة وحيويتها، وبالحركة وديناميتها، وبالإنسان وتطلعاته، ولا يرتبط بالأعمار ومحدداتها.
من تلك المقالة التي سردت فيها ما تيسر لي من سيرته الإبداعية انطلقت أول الأفكار التأسيسية لـ(ببليوغرافيا محي الدين زنگنه) وعندما طرحت الفكرة عليه قال ادخل إلى غرفتي، واطلع على مكتبتي، وخذ منها ما يخدم مشروعك هذا. لقد وضع المكتبة كلها تحت تصرفي، وصرت أتردد على بيته كثيرا. فكلما احتجت صحيفة ما رحت ابحث عنها في ركام من المجلات والصحف التي كانت تزدحم بها غرفة مكتبه في الطابق العلوي. وكم كنت اشعر بالحرج حين يطول بحثي عما أريد حتى أنني طلبت منه أن احمل كل تلك الصحف إلى بيتي لأرشفتها بالطريقة التي أريد. لم يشعر بالخوف على تاريخه الأدبي الموثق بتلك الصحف حين حملتها بعناية إلى داري..نثرتها على الأرض، وطلبت معونة زوجتي في ترتيب التواريخ المتقاربة للنشر. صنعت ألبوماً كبيرا وأنيقاً من الورق المقوى، وبدأت بقطع المقالات ولصقها على ذلك الألبوم حتى انتهيت منها جميعا وكانت في ثلاثة أجزاء: الأول والثاني تضمنا على ما كتب عن مسرحه وأعماله الروائية والقصصية بينما تضمن الثالث على مقالاته التي نشرها في المجلات والصحف. واستنادا إلى هذه الألبومات الثلاثة استطعت كتابة أضخم ببليوغرافيا عن كاتب عراقي نشرتها كفصل أخير في كتابيَّ: البناء الدرامي في مسرح محي الدين زنگنه، والمخيلة الخلاقة في تجربة محي الدين زنگنه الإبداعية.
لم تكن تلك المقالة لتأخذ شكلها النهائي، فكلما تعمقتُ في معرفته كلما صغرت مساحتها وبات من الضروري إعادة كتابتها مرة أخرى وأخرى. وكلما طلبت منه بيان وجهة نظره فيها كلما أمعن في صمته الجليل. كان يحدثني فقط عن جانبها الفني وربما اللغوي أيضا أما ما يتعلق به فذلك ما لا يطرق بابه أبداً. إن كل من عرف زنگنه عرفه بتواضعه الكبير. ذلك التواضع الذي أقلقني، وشوشني، وجعلني أتساءل دوماً: إذا كان زنگنه بكل عطائه الفذ يشعر بهذا القدر الهائل من التواضع فما بالنا نحن الذين نتفيأ بظلاله الوارفة.
عندما نشر مجموعته القصصية الأولى (كتابات تطمح أن تكون قصصاً) حرص على أن يقدمها ككتابات تطمح أن ترتقي إلى مصافي القصة القصيرة. وهذا تواضع آخر من كاتب قصصي لفتت كتاباته انتباه القاصي والداني من القراء والنقاد. لم يشعر يوما انه قدم منجزاً كبيراً، ولم اسمعه يوما يفاخر بنصه أو نفسه، وكثيرا ما كنت أحمل نصاً من نصوصه لأسلمه باليد إلى هذه المجلة أو تلك. لم يكن مهتما بالشهرة ولا بالأضواء لهذا احتاج فريق عمل من تلفاز بغداد بقيادة المخرج الفنان رضا المحمداوي إلى وساطتي وإصراري وملحتي ليوافق على تسجيل حلقة خاصة به في برنامج (مبدعون من تلك المدن) وكانت حصتي من الحديث قد أظهرتني على الشاشة كما لو أنني ساهمت في إعداد البرنامج بقدر ملموس.
(ببليوغرافيا محي الدين زنگنه) فرضت علي قبل أن تأخذ شكلها النهائي قراءة كل ما كتب عنه في المجلات والصحف، وكل ما كتبه في المجلات والصحف، فضلا عن كتبه المطبوعة والمخطوطة حتى اعتبرني بعض الأخوة عرّاب زنگنه الأول. عندما شرع الأستاذ مؤيد عبد القادر بإعداد كتابه الموسوم (هؤلاء في مرايا هؤلاء) وهو كتاب اعتمد استكتاب المعروفين من النقاد للكتابة عن الشخصيات العلمية، والفنية، وذات الانجاز الإبداعي المتميز اخترت للكتابة عن زنگنه، ولم أكن حينها ناقداً معروفا ربما في بعقوبة فقط. عدت إلى الببليوغرافيا نفسها والى المقالة نفسها وبدأت بإضافة التفاصيل المهمة بعد أن غيرت عنوانها إلى (السهل والجبل) مستخلصا هذه العنونة من انتماء زنگنه الحقيقي البحت للعراق بعربه وأكراده فاستأثرت باهتمام المعد الأستاذ مؤيد عبد القادر فوضع مقدمة لها على غير عادته في هذا الكتاب أشار فيها إلى أهميتها والى الأسلوب الذي اتبعته في الابتعاد بهذا القدر أو ذاك عن السيرة الذاتية التقليدية التي حفل بها الكتاب فنشرها كاملة على الرغم من حجمها الذي فاق حجم المقالات الأخرى. جاء في تلك المقدمة ما يأتي:
"سيلاحظ المتابع لفصول هذا الكتاب أن الناقد صباح الانباري حاول في شهادته عن الروائي الكبير محي الدين زنگنه أن يعتمد أسلوب المقالة النقدية، مبتعدا بهذا القدر أو ذاك، عن أسلوب السيرة الذاتية التي درجنا عليها في هذا السفر. ولأهمية الروائي الكردي العراقي الكبير محي الدين زنگنه ولجهوده الإبداعية الثرة فلقد حرصنا على تثبيت هذه الدراسة النقدية دون أن نتدخل بأي قدر كان في تفاصيلها، موفرين لصديقنا الناقد الانباري حرية اختيار الأسلوب وبالطريقة التي يراها مناسبة، لسببين مهمين، الأول: هو أن كاتب الدراسة واحد من أدباء المحافظات ومن حق هؤلاء المبدعين علينا أن نفسح المجال أمامهم واسعا ليطلع القراء على إبداعاتهم الكبيرة، ذلك لأننا نعرف تماماً بان الأضواء تسلط ـ عادة ـ على الأدباء الأقرب إلى العاصمة ومؤسساتها الثقافية! أما الثاني فلخصوصية الروائي المبدع محي الدين زنگنه الذي قدم نفسه إلى الوسط الثقافي العراقي والعربي منذ وقت مبكر مبدعا كبيراً صنعته التجربة الصعبة دون أن تتدخل في (صناعته) أهواء ومصالح وأوهام!.............................(المحرر)"
وعندما أزمع معد الكتاب مؤيد عبد القادر إقامة حفل توقيع لكتابه أرسل لنا دعوتين لحضور الحفل في العاصمة بغداد وبعد الانتهاء من الحفل توجهنا معاً إلى مقر اتحاد الأدباء لإكمال السهرة في ناديه الليلي. كان زنگنه مولعا بجلساتنا الليلية ففيها ننفتح على بعضنا بأحاديث الفن والأدب والمزاح الذي كان يتقن أساليبه وأحابيله ولكنه في الوقت نفسه يتخذ أقسى المواقف وأشدها تعصباً إن أحس أن وراء المزاح محاولة خبيثة للنيل منه شخصياً. في تلك الجلسة حاول شاعر صديق أن يسئ إليه بتلميح مقصود أو غير مقصود لا أدري بالضبط فلم أكن منتبها بشكل جيد بعد احتساء زجاجتين من البيرة الألمانية، وكان قد أهدى إليه إحدى مسرحياته الجديدة فما كان من زنگنه إلا أن استرجع هديته واقتطع من الكتاب الورقة التي كتب عليها الإهداء ومزقها وقذف بها إلى سلة المهملات. ولم ينفع اعتذار الشاعر له بعد ذلك ولا حتى تقبيل يده إكراما واحتراماً فعدنا إلى بعقوبة وقد سيطر علينا الإحساس العميق بالكآبة.
كان زنگنه كما هو في كتاباته لا يساوم على شيء، ولا يتراجع عن مواقفه السديدة، ولا يتنازل عن أفكاره ولا عن البوح بها لكنه في الوقت نفسه كان يحصن نفسه، وكتاباته ضد سياسة الرقيب، وسطوته، ونفوذه. ولهذا لم تستطع السلطة آنذاك أن تتهمه بشيء محدد مع علمها بحقيقة توجهه اليساري، وفكره التقدمي. أتذكر يوم وجهت له الدعوة من مصر لحضور عرض مسرحيته (السؤال) أو (ما حدث للطبيب صفوان بن لبيب من العجيب والغريب) أحيل طلب سفره على غير العادة إلى وزير الثقافة لطيف نصيف جاسم فما كان من وزير الثقافة إلا أن أحال طلبه إلى وزارة التربية والتعليم بحجة انه كان قبل تقاعده واحداً من منتسبي الوزارة كمدرس للغة العربية. وحين قدم الطلب لوزير التربية والتعليم أحاله بدوره إلى وزارة التخطيط خوفا من تعارض سفره مع خططها. وهكذا حرم زنگنه من مشاهدة عرض مسرحيته على الرغم من أنها عرضت في مصر مرتين مرة من قبل فرقة مسرح الإسكندرية من إخراج الأستاذ محمد غنيم، وأخرى من قبل فرقة المسرح الجامعي من إخراج الأستاذ صلاح مرعي. كما عرضت من قبلُ في الكويت وتونس وكانت من إخراج الفنان القدير المنصف السويسي فضلا عن عرضها في بغداد بإخراج متميز للفنان الراحل الكبير جعفر علي. لقد رفضت الوزارات طلبه في الوقت الذي لم تكن حاجة لغيره في الحصول على تلك الموافقات.
عندما قررت جامعة ديالى/ قسم اللغة العربية تدريس مسرحيته الموسومة (رؤيا الملك) أو (ماندانا وستافروب). كمادة لدرس النقد الأدبي فأنها اختارتني لأكون محاضرا فيها. كانت تلك التجربة لا تخلو من بعض الصعوبات غير المحسوبة فهي المرة الأولى التي أحاضر فيها داخل صف جامعي إلا أن ثقة رئيس القسم د. فاضل التميمي حالت دون وقوع غير المحسوب. جلست أمام طلاب القسم، وكان إلى جانبي أستاذ اللغة العربية الراحل الذي قتل مع زوجته غدرا على أيدي شلة من الإرهابيين د. مشحن الدليمي. قدمني د.فاضل لطلاب قسمه قائلاً: "من لا يعرف صباح الانباري لا يعرف محي الدين زنگنه" لقد جعل مني بوابة الدخول إلى عالم زنگنه. وبعد محاضرتين فقط تولع الطلبة بحب الدراما وازدادوا إعجابا بزنگنه حتى أن بعضهم أختار أدب زنگنه الدرامي كبنية أساسية لرسالة الماجستير. وفي نهاية العام الدراسي قدمت مجموعة من البحوث عن زنگنه وكرم كواحد من اكبر المبدعين العراقيين.
عندما أقيم مهرجان گلاويژ في السليمانية وجهت الدعوة لي للمشاركة بدراسة جديدة عنه حيث ألقيت على الحضور ـ في اليوم المخصص للدراسات العربية ـ دراستي الموسومة (البوح المكتوم في كتابات محي الدين زنگنه الإبداعية) والتي تطرقت فيها إلى ما لم استطع البوح به من قبل لأسباب تتعلق بقمعية النظام الديكتاتوري السابق. وأشرت إلى جرأة زنگنه في تحميل كتاباته بالرموز والإشارات التي فضح بوساطتها سلوك النظام الديكتاتوري، وأساليبه القمعية لتدجين، وتنميط، وتحجيم العقل العراقي. لقد سبق لي القول عن تواضع زنگنه الذي لا يحده حد ولكن على الرغم من هذا التواضع الكبير إلا انه لا يرضى أن ينظر إليه كقيمة متدنية إطلاقا فقد رفض الإقامة في غرفة بائسة داخل فندق شعبي في الوقت الذي أسكنوا فيه بقية الأدباء في غرف الدرجة الأولى وما كان من المسؤول عن الإقامة إلا الرضوخ لمشيئة الجبل الأشم، وعلى الفور قام بنقلي وإياه إلى غرفة مريحة في فندق المدينة الكبير. وكالعادة انهالت علينا دعوات الأدباء لمجالسهم المسائية التي يتألق فيها زنگنه بحضوره المهيمن، وبشخصيته الفريدة، وأحاديثه المشوقة، ونكاته اللطيفة. وكان من عادة المهرجان أن يسمي أيامه بأسماء الأدباء الكرد فأطلق على يوم القصة يوم محي الدين زنگنه.
في بعقوبة كان لزنگنه قلة قليلة من الأصدقاء المقرّبين كالفنان التشكيلي الكبير منير العبيدي، والمسرحي السابق مجيد مبارك، وغيرهما من الأصدقاء. وعندما كتبت مسرحيتي الثانية (ليلة انفلاق الزمن) ـ وهي من الخيال العلمي أيضاً ـ كان هؤلاء الأصدقاء إلى جانب زنگنه أبطالها. في هذه المسرحية جعلت الزمن ينفلق ليشكل زمنين الفرق بينهما 25 عاما حيث تتم المواجهة المباشرة بيننا وبين من هم يمثلوننا. وينشأ بيننا صراع ضار لا هوادة فيه لإثبات من هو الحقيقي منا. وكيف وجدنا معا في آن واحد وبعمرين مختلفين يكبر أولهم الآخر بخمس وعشرين سنة. المسرحية تبدأ من جلسة مسائية من جلساتنا المعتادة لتنتهي بنا إلى السجن على ذمة التحقيق. لم تكن هذه المسرحية أو التي سبقتها العمل الإبداعي الوحيد الذي احتفى بزنگنه فقد سبقهما فيلم تلفازي بعنوان (الكاتب الظريف) والذي أخرجه الفنان ناصر حسن لصالح تلفزيون بغداد. وبعد هذا الفيلم جاءت قصيدة الشاعر إبراهيم الخياط الموسومة بـ(محي الدين زنگنه) عام 1993، لتشكل سبقا في الكتابة الشعرية عن زنگنه. وفي عام 1998 كتب الشاعر إبراهيم البهرزي قصيدته الموسومة بـ(محي الدين زنگنه). وفي عام 2000 كتب الشاعر الكردي شيركو بيكس قصيدته الموسومة بـ(محي الدين زنگنه) أيضاً.
عندما ابتكرت وزارة الثقافة العراقية جائزة للإبداع تحت مسمى (جائزة الدولة للإبداع) نالها بجدارة عالية عن مسرحيته الموسومة (رؤيا الملك) عام 1999 ثم نالها ثانية عن مسرحية (شعر بلون الفجر) عام 2001 وكنت قد نلتها بعده عن مسرحيتي التجريبية (الصرخة) عام 2000. الغريب في الأمر أن المسرحيات الثلاث كشفت النقاب ـ بشكل يكاد يكون واضحاً ـ عن وجه السلطة القبيح والدموي ولكنهن على الرغم من هذا نلن جوائز الإبداع. لقد فرضت نصوص زنگنه نفسها على المسرح العراقي في مواسمه المختلفة، ولم تدخل مسرحية من مسرحياته دورة من دورات مهرجان بغداد المسرحي إلا وفازت بجائزة أحسن نص في المسرح العراقي. إن زنگنه وعلى الرغم من كل هذا لم يرغب في الظهور تحت الأضواء وان الكثيرين ممن أحبوا مسرحه لم يسبق لهم رؤيته وجها لوجه..أتذكر عندما قدم منتدى المسرح واحدة من مسرحياته التجريبية الموسومة بـ(القطط) ذهبنا إلى قاعة العرض بصحبة القاص شوقي كريم فوجدنا القاعة ممتلئة حتى آخرها بجمهور النظارة، ولم نجد إلا ثلاث مقاعد شاغرة في الصف الأول فجلسنا عليها، وما هي إلا لحظات حتى جاء أحدهم، وطلب من زنگنه إخلاء الكرسي لأنه كرسي الوزير. ثارت ثائرة شوقي وقال بصوت مسموع (والصوت المسموع في تلك الفترة العصيبة يؤدي إلى السجن..و..و..الخ):
"ابني هذا محي الدين زنگنه..ليس للعراق منه غير واحد فقط..أما الوزير فعندنا منه الكثير اذهب وقل له هذا"
غادر الرجل خائفا وكأنه هو الذي قال هذا الكلام وليس شوقي كريم. وعندما انتهى العرض وبدأت الجلسة النقدية وتحدث فيها من تحدث طلبوا من زنگنه أن يقول كلمة ما، فبدأ بالحديث من محله، ولكن جمهور النظارة ألحّوا على مدير الجلسة أن يتحدث زنگنه إليهم من المنصة ليتعرفوا عليه وليروا وجهه للمرة الأولى فما كان منه إلا أن ذعن لمحبتهم.
وأنا اكتب هذه السطور ذكر لي زائر كريم، وصديق حميم أن زنگنه لا يجيد الكلام مثلما يجيد الكتابة وهو لهذا لا يريد إجراء لقاء، أو حوار مع الصحافة. قلت ليس هذا هو سبب رفضه للحوارات واللقاءات الصحفية مع أنني لا اجزم أن الكاتب ينبغي أن يكون متحدثا جيدا بالضرورة لكن زنگنه اثبت في مناسبات كثيرة فصاحة لسانه، وبلاغة كلامه، وطلاقة لغته، وقدرته الكبيرة على نطق الظاء والضاد والذال، ومكنته اللغوية في الكتابة الإبداعية، ولغة الحوار المباشر في آن واحد. فقط كان لا يرغب في أن تسلط عليه الأضواء لأنه يدرك فداحة الثمن الذي ينبغي دفعه للسلطة وقتذاك خاصة لمن تسلط عليهم الأضواء في الإذاعة أو التلفزيون أو الصحف الرسمية. وهذا هو السبب أيضا وراء عدم كتابتي عن نصوصه بطريقة تلفت أنظار السلطة إلى بوحه المكتوم.
انتهى الجزءالاول