

المسرح العربي من الاستعارة الى التقليد
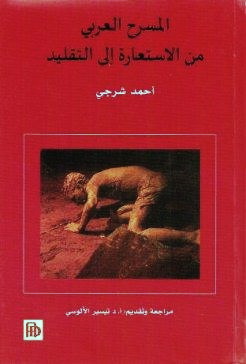
قراءة وعرض صباح الأنباري
تتحدد موضوعة أيّ كتاب نقدي بعنونته فهي ثرياه، ونبراسه، وبسملته، ومفتاحه للدخول
الى عالم تلك الموضوعة. وفي عنونة الكاتب المسرحي أحمد شرجي (المسرح العربي من
الاستعارة الى التقليد) نجد أنه حدد اشتغاله في هذا الكتاب على المسرح العربي
حصراً، كموضوعة رئيسة لفصول الكتاب، وحدد مساحة اشتغاله على تلك الموضوعة (من
الاستعارة الى التقليد) في إشارة إلى أن المسرح العربي لم يكن ذا أصل عربي، وأن
العرب استعاروه من الغرب (من محل الولادة والنشأة والنمو) عن طريق روادهم الأوائل
الذين نقلوا مشاهداتهم لعروض مسرحية في أوربا - كمقلدين لتلك العروض- الى لبنان
وبلاد الشام، ومصر، والعراق. وعلى الرغم من أن موضوعة الكتاب، ومن خلال العنونة
أيضاً، توقفت عند حدود التقليد إلا أن الكتاب تجاوزها لمراحل أخرى أكثر نضجا وأهمية
في العملية التأصيلية بل انه خصص فصولا بكاملها لدراسة تطور المسرح العربي ونظرياته
وتطبيقاته المختلفة، وكان حريا بالكاتب أن يضيف للعنونة ما يجعلها تفصح عن كامل
اشتغاله من الاستعارة إلى التقليد فالتأصيل والتنظير.
الكتاب بدأ رحلته الطويلة بتقديم مفصل للأستاذ د. تيسير الآلوسي الذي أكّد منذ
البدء على أن "المسرح قيمة جمالية سامية في مسيرة الإبداع الإنساني" لينتقل إلى عرض
مادة الكتاب والتعريف بمؤلفه الذي جمع في كتابه "عددا من القراءات والابحاث التي
انجزها" بعد أن "تعفر جبينه بتراب خشبة المسرح طويلا". ولم يكتف د. تيسير الآلوسي
بتقديم الكتاب بل قام بمراجعته مراجعة اكتفت بالجانب المعلوماتي حسب ليبدأ المؤلف
بعده انطلاقته من الرمزية باعتبارها الثورة الشكلية التي قوّضت الواقعية،
والفوتوغرافية، والطبيعية بقيادة علمين بارزين من أعلامها العتاة هما: أدولف آبيا،
وكوردن كريك فضلا عن جان لوي بارو الذي اشتهر بأعماله الإيمائية. في هذه المادة
التمهيدية ألقى المؤلف الأضواء كاملة على هاتين الشخصيتين الرافضتين للواقعية التي
تبنتها أغلب المسارح وقتذاك كجانب من جوانب ائتلافهما، ووضح جوهر التباين بينهما من
خلال نظرة كل منهما للديكور فأبيا يجد "أن ارادة المؤلف المسرحي هي اللغة الفنية
الموحدة التي يسترشد بها الديكور" بينما يجد كريك في كتابة المؤلف لتلك الملاحظات
مصادرة تعسفية لروح الإبداع وقتلا للذائقة الفنية كما ورد على لسان الباحث. وعلى
الرغم من أن المادة التمهيدية أكدت على الجوانب المهمة في منجز العلمين، كتحديد
العناصر التشكيلية في تصميم المشد المسرحي، أو منح الممثل "كوحدة قياس" تحاول ترتيب
العناصر الجمالية، إلا أنها لم تكن ذات صلة قوية بالمسرح العربي، وأن المسرح العربي
لم يبدأ منها فبدايته انصبت على التقليد أولا ثم حاولت الخروج من التقليد إلى
الـتأصيل، وإلى خلق الهوية العربية للمسرح.
في الفصل الأول تناول المؤلف موضوعة (إشكالية التأصيل والهوية في المسرح العربي)
مبتدئاً الفصل بنظرة تاريخية للمسرح العربي ورواده الأوائل: مارون النقاش، وابو
خليل القباني، ويعقوب صنّوع. ومن الجدير بالإشارة هنا أن الهفوة التي وقع فيها
المؤلف هي ذاتها التي وقع فيها من سبقه إلى الكتابة عن هؤلاء الرواد، أو عن تاريخ
المسرح العربي فلم يكن يعقوب صنّوع رائدا للمسرح العربي في مصر، كما جاء ذلك في
كتابات د. محمد يوسف نجم وغيره الذين نقلوا عن نجم تلك المعلومة الخاطئة ومنهم كاتب
هذه السطور في كتابه (المقروء والمنظور.. تجارب ابداعية محدثة في المسرح العراقي
2010) ، بل هو سليم النقاش. وللمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة ينبغي الرجوع إلى
كتاب (البوم أبو نظّارة يعقوب صنّوع.. دراسة وتعليق د. سيد علي). الذي يفضح بشكل
واضح لا لبس فيه أكبر أكذوبة مسرحية صاغها لنفسه يعقوب صنّوع بمساندة مؤسساتية
هدفها المساس المباشر بقلب الثقافة العربية. ومما فات المؤلف ذكره هنا هو أن المسرح
بدأ في العراق بحدود عام 1880 على يد الشماس حنا حبش في الموصل الذي خلّف لنا ثلاثة
نصوص مسرحية ممهورة بمهره الخاص ويمكن الرجوع اليها ضمن أرشيف دائرة السينما
والمسرح أو في موقعي الالكتروني الشخصي (نسخة مصورة عن الأصل).
ومن استنتاجات هذا الفصل المهمة أن المؤلف وضع يده على الأسباب التي أدت إلى عدم
تطور المسرح العربي، أو التقدّم على ما جاء به مارون النقاش موعزاً تلك الأسباب إلى
القطيعة التي فرضت بين المسرح وبين إرثه الفرجوي، وإلى الإسلام الذي فرض المحرمات
على الحريات وترك الجسد أسير تابو منعه من التحرر ومن اطلاق قدراته التجسيدية. ثم
ان الدعوة الإسلامية هدّمت كل ما يمت إلى الوثنية بصلة. يقول المؤلف نقلا عن كتاب
فاروق خورشيد (الجذور الشعبية للمسرح العربي): "إن الانقطاع هنا حاسم ولا تردد فيه،
فكل ما هو طقس وثني انتهت آثاره ودرست مبانيه، وامحت معالمه، وهو اذا أفلت في بعض
النقوش والبرديات القديمة في حالات نادرة، فإنه لا يعطينا صورة واضحة لمراحل التطور
أو الاشتغال من العرض المعبدي الخالص الى العرض المسرحي العام وحتى هذا لم يتم إلا
لبعض إشارات في متبقيات العبادات السومرية والفينيقية القديمة".
وفي جانب الصراع فان المؤلف يرى أن المسرحية تأليفاً وعرضاً تقوم على الصراع فهي
حاضرة به وغائبة بغيابه، وبما أن العقلية الإسلامية نظرت إلى الله والملائكة
والصحابة.. إلخ، بوصفهم قضية محسومة ربانياً فإن هذه النظرة وانطلاقا من قدسيّتها
لم تسمح بقيام أي نشاط تجسيديّ، وعدّت إبراز أهل البيت أو الصحابة وتجسيد شخصياتهم
على الخشبة أمراً يمس تلك القدسية مما أدى في النتيجة إلى طمر التعازي وعدم تطورها
كتراجيديا إسلامية عربية.
وفي قراءة المؤلف للإخراج والتنظير في المسرح العربي يرى أن النص المسرحي بدأ
وانطلق من بيت مارون النقاش، وأنه تطور على أيدي عدد من رجالات المسرح والمشتغلين
على مده بالروح الحية والحيوية أمثال الحكيم في مسرحه الذهني، وخروجه بالعمل
المسرحي من العلبة التي وجد فيها إلى الأماكن العامة. يقول المؤلف مستنتجاً: "إن
الحكيم اراد لمشروعه المسرحي، العودة الى البدائية أو النبع الصافي كما اطلق عليه،
وذلك يكون بتوظيف كل الفنون، هذه الفنون أو الاشكال الفنية، لم تأت عن طريق تأثيرات
الثقافة الأوربية، بل هي مظاهر اجتماعية خالصة داخل الثقافة المصرية والمجتمع
المصري".
أما يوسف إدريس فقد دعى هو الآخر إلى وضع خصوصية للمسرح العربي برجوعه إلى مسرح
(السامر) الذي عرفته الجماهير العربية فيما مضى. لقد كانت دعوة إدريس مقتصرة على
الجانب النظري، ومنطلقة من الورق والتنظير وهي لهذا عدّت تجربة نظرية لم تستطع
مقاومة الزمن، ولا الحفاظ على مقوماتها ذلك لأنها وبحسب المؤلف "لم تنطلق من داخل
مختبر مسرحي".
في تناول المؤلف لتجربة الكاتب العراقي يوسف العاني يشير إلى مسرحية نعوم فتح الله
السحار (لطيف وخوشابا1893) كأول نص مسرحي عراقي وقد بيّنا خطأ هذه الفكرة عندما
أشرنا إلى مسرحيات الشماس حنا حبش الثلاث (كوميديا آدم وحواء، كوميديا يوسف الحسن،
كوميديا طوبيا) التي كتبها بحدود عام 1880. وعلى الرغم من اتفاقنا المبدئي على
ريادة نصوص الشماس وبعدها نص نعوم فتح الله السحار إلا أننا لم نجد ما يعزز
ريادتهما من الوثائق الرسمية والصحفية. لقد أسهب المؤلف في الحديث عن يوسف العاني
الذي تبنّى نظرية بريخت الملحمية متناولا نصه الموسوم بـ(المفتاح) والمؤسس على
حكاية شعبية تراثية وكنا ننتظر منه الحديث عن جانبها الإخراجي، وما أضافه المخرج
إليها ولكنه اكتفى بدراسة النص مستنتجا أن المسرحية تعد "فتحاً في الكتابة المسرحية
الجديدة في العراق، هذه الريّادة تجسدت في لجوء الكاتب للفلكلور الشعبي وتوظيفه،
لإسقاطه بما يلائم الحكاية المعاصرة".
في فصل (التصورات الإخراجية في العرض المسرحي) يؤكد المؤلف على أن التأثير الغربي
استمر على المسرح العربي من أيام مارون النقاش وحتى الزمن الحاضر. وشمل هذا التأثير
الجوانب الحيوية في العملية المسرحية. وقد استمر تقليد التجارب الغربية او تبنّي
مشاريعها جزئيا أو كليا في المنطقة العربية كما هو الحال مع روجيه عساف ونضال
الأشقر في محترف بيروت. والمسرح الجديد لفاضل الجعايبي وفاضل الجزيري. أما الطيب
الصديقي فقد حاول الابتعاد عن استنساخ التجربة ومنح تجاربه الخاصة روحا محلية خالصة
كمل آثر صلاح القصب أن تكون تجربته مستقلة عن (مسرح الكادر الروماني) مطلقا على
تجربته اسم (مسرح الصورة).
في الفصلين الأخيرين تناول المؤلف تجربتين محدثتين:
الأولى للمخرج العراقي د. جواد الأسدي والمتمثلة في كتابته ليوميات البروفة
المسرحية بشكل تفصيلي. فهي بمثابة سِيَرٍ للأعمال المسرحية التي أنتجها وتناول فيها
مشاكل العمل الإخراجي والتمثيلي والسينوغرافيا وبعض هموم وهواجس العمل وتداعيها أو
تأثيرها على سياق البروفة.
والثانية للناقد المغربي سعيد الناجي الذي يشكّل "ركنا مهما من اركان المشهد النقدي
الجديد في المغرب، والذي "انتقل بمشروعه النقدي من القراءة للظاهرة النقدية للظاهرة
المسرحية إلى تفكيكها ومناكفتها بوعي متقد، بعقلية الناقد الاكاديمي المتمكن من
أدواته الإشتغالية، عقل أركيولوجي بامتياز".
في خاتمة الكتاب يتوصل المؤلف إلى أن الكلام الذي يدور حول الهوية الخاصة للمسرح
العربي، أو أي مسرح آخر إنْ هو إلا محض مغالات ومغالطات ذلك لأن المسرح بشكل عام لا
تؤطره الهوية والبلد والأرض. ولا يوجد ما يطلق عليه مسرحا إنكليزيا أو هولنديا أو
عربيا بل هناك اسماء صنعت لنا أشكالا متفردة في كل تلك البلدان وفي كل ساحة من
الساحات المسرحية في انحاء العالم.
ومسك الختام دعوة أطلقها المؤلف للاهتمام بصناع التجربة المسرحية، وتوفير مستلزمات
تجاربهم الإبداعية والأخذ الجاد بها، وتبنيها مؤسساتيا.
وبعد هذا وذاك تظل قراءة فصول هذا السفر العلمي المشرق مهمة أساسية من مهام القارئ
المسرحي، والمثقف العضوي لما تتسم به من الصدق، والموضوعية، والتحليل الدقيق
لتفاصيل حياتنا المسرحية.