

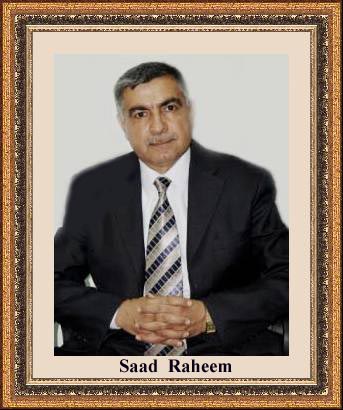
سعد محمد رحيم
محنة القرين التوالدي في قصة: الهرب من الدهاليز القديمة
صباح الأنباري
في قصة
سعد محمد رحيم (الهرب من الدهاليز القديمة) ثمة أمران بارزان في عنونتها هما: الهرب
كفعلٍ وردّ فعل في آنٍ واحد، والدهاليز كمكان حاضن للهرب. وما قبلهما مجموعة أحداث
سكت السرد عنها كمسبب لتداعيات الهرب إلى خارج المكان أو داخله ضمن مساحة محددة
واقعياً بين الباب وبين الدار، وخيالياً بين اللحظة وعشرات وربما مئات اللحظات
الذهنية الشاردة من مخيلة الهارب. الحدث أو مجموعة الأحداث التي سبقت السرد تتحدد
من خلال ما بثه السرد من شفرات مرسلة بعد عنونته مباشرة والى آخر نقطة في نهايته
متجلية في كلّ خطوة على تلك الدهاليز التي اتصفت بالقدم (القديمة) في اشارة إلى
ماضيها المكتظّ بالأسرار، والغموض، والتداعيات الذاكراتية التي يتداخل بعضها مع
بعضه الآخر بطريقة سحرية عجيبة تخلخلها تاركة فجوات لا يمكن ردمها أو التأثير عليها
من خارجها فهي تتحكم بطريقة خروجها وانزياحها، وتشابكها مع ما شاء لها من المكنونات
الذاكراتية المختزنة. لقد أكد العلماء على وجود حافز يحث الذاكرة لتعمل ذاتياً على
تحريك مخزونها خاصة ذلك المزود بالأفعال القوية أو العنيفة التي تزيح ما دونها
لتتقدم عليها ولتستلم الحث وتتفاعل معه بطريقة يندر السيطرة عليها. ومن هنا نستنتج
أن شخصية السارد في القصة إنما وقعت تحت هذا المؤثر العجيب.
يقول السارد في مفتتح قصته:
"لتوّي
أدركت أن الآخر الذي ظل يراقبني منذ ساعتين هو أنا، أيضاً!!"
في هذه
الجملة الافتتاحية ثمة أمران أيضاً هما إن زمن الحدث الرئيس وقع قبل ساعتين من بدء
السرد، وإن الشخصية القرينة لم تظهر إلا بعد ذلك الحدث بالضبط. ومهما غالينا في
تحديد هوية ذلك الحدث فإننا لن نصل إلا إلى حقيقة كون الشخصية واقعة الآن تحت فعل
الحث الذي تحدثنا عنه وأفقدته قدرة الادراك الواضح والسليم لما تراه عيناه، وهذا
يأتي بالضد مما ادعته الشخصية من أنها أدركت وجود شخص آخر يقف إزاءها. وما إدراكها
إلا لغرض التمويه الذي يرضي في نفسها ما تروم إليه في هذه اللحظة الحرجة والمخلخلة.
قد يكون الحث هنا عبارة عن مخدر أو ترياق لإيقاف وعي الشخصية فهي مصابة بجرح كما
ستخبرنا القصة بعد قليل وما هذيانها المحموم إلا نتيجة منطقية لتأثير ذلك المخدر
فهو يعمل على جعل الجسم يستسلم لقوته وفي الوقت نفسه يحث الدماغ على الاشتغال
بطريقة مضادة في محاولة لإيقاف سريان الخدر إليه. ماذا يريد الكاتب من كلّ هذا؟
يريد
أن يخبرنا إن الشخصية المستوحدة قد تراكمت عليها ضغوط لا طاقة لها على تحملها
فظرفها قاهر ومحبط، وبيئتها عنيفة وضاغطة، وليس ثمة ما يشير إلى انحسارهما، لهذا
وبسببه نجدها تجترح قُرناءَها بشكل توالدي ثم تقوم بالتمويه عليهم لسببين: الأول
فني فرضه النسق السردي الذي اختاره الكاتب ليكون البيئة المثلى للشخصية وهي في حالة
انكسارها، والثاني ذاتي يعالج ضعف قدرتها على تأكيد شخصيتها المنكسرة. تقول على
سبيل المثال لا الحصر عن القرين الأول:
"هو
لا يشبهني كثيراً، أو هو لا يشبهني على الإطلاق"
فالنفي
هنا وتأكيد النفي علامتان تعملان على تبديد المؤكد، وبحسب اعترافها اللاحق أو لنقل
تبريرها عدم الابصار بوضوح تكون قد أعطتنا التأكيد على أن القرين إنما هو قرينها
الذي انفلق عنها فحصل على شيئين: هيئتها المشابهة، وجوانيتها المختلفة. بمعنى آخر
أن القرين تحوّل إلى مرآة قادرة على عكس ظاهر الشخصية، وكشف باطنها في آن واحد. هذا
التذبذب والارتباك هو في حقيقة الأمر نتاج وقوع الشخصية تحت مؤثر الحث الذي جردها
من الثبات على موقف واحد وهي القائلة:
"فلربما
يشبهني، لكنه ( أنا ) في نهاية الأمر"
ففي
هذه الجملة المهمة جدا (حسب رأيي الشخصي البحت في حالة دراسة هذه الشخصية) يقدم لنا
الكاتب حجم الارتباك بين (ربما) التي يراد بها الإكثار بمعنى الود (يودّ) وهذا يعني
أن الشخصية تودّ أن يكون القرين مثيلها فعلاً، وبين الـ(أنا) المسبوقة باستدراك
ظاهر لرفع والغاء توهّم حصل من كلام سابق (هو لا يشبهني) بغرض التصحيح الذي يؤكد
لنا اضطراب الشخصية واهتزاز موقفها، وتشوش ذاكرتها حد أنها لا تستطيع الجزم أن
اسمها هو سعيد بن رشيد العطار وهذا جعلنا نتعاطف معها، ونشفق عليها لأسباب أهمها
أنها تعاني من إصابة بليغة أدّت إلى تدفق الدم ("أطلق عليّ النار/ أنزف على
الرصيف") إصابة وقعت قبل بدء منظومة السرد اشتغالها على ما حدث داخل الدهاليز، وأدت
إلى زعزعة يقينها، وخربشة سطح ذاكرتها الانفعالية. تقول متسائلة:
"أهذا
اسمي حقاً، لست أذكر غيره.. شيء غريب أن يخطر لي أن اسمي هو؛ سعيد بن رشيد العطار.
كأنني على ثقةٍ من هذا"
مما
يعني أن الشخصية بدأت اللعب على حبال الاستهام لكسب الكثير من الشفقة التي تشتغل
على تهيئة الأرضية الملائمة للمزيد من الموازنة بين الأنا والآخر، أو بين الأصل
الممتلئ والفرع الخاوي انطلاقاً من الفروق الواضحة بين الجسد المادي والجسم
الأثيري. هذه اللعبة استهوت الشخصية وجرّتها إلى ممارسة دورها في الخداع بعيداً عن
الحث المؤثر في فيزيائية عمل دماغها. تقول على سبيل المثال مستدركة:
ولكن
لماذا سعيد وأنا لم أكن سعيداً في أي يوم؟
هذا
استدراك في لبوس استفسار غير بريء يقع خارج الحث المؤثر فيزيائيا على عملية اشتغال
الدماغ كما اسلفنا وهو يشير هنا إلى أن الاستهام مقصود في ذاته ومؤكد في جملة أخرى
تفصح عن قصدية واضحة. تقول الشخصية:
"أما
أبي فلم يكن رشيداً قط في أي من القرارات الكبيرة التي اتخذها من غير حكمة وتحسّب،
والتي حددت مصيري لاحقاً"
وهذا
يعني أن علينا استبعاد الحث وأداته الفاعلة المخدرة قبل أن ننتهي من حكمنا على
الشخصية التي ستراوغنا مرة أخرى، وتوقع بنا في شباك الايهام المريب عندما يتوالد
عنها قرين مختلف تهيّئنا لاستقباله من خلال كم هائل من البيانات والأسئلة المبنية
على التضاد المقصود مثل: "أعرف ولا أعرف" و "الدموع تشوِّه المرئيات حيناً،
وتوضِّحها، بأكمل ما يكون الوضوح، حيناً آخر" و "كم من الوقت نمت، أو كم من الوقت
غبت عن الوعي" وهنا تجدر الإشارة إلى قدرة الكاتب على ابتكار انساق حيوية لشخصية
السارد فيتمكن من نقل مؤثراته الاستهامية إلى المرأة نصف العارية: "تمرر إصبعها على
ما تظنه الجرح، أو تجعلني أتوهم الجرح" ويتداخل الوهم بالحقيقة حد اننا نعجز أحيانا
عن فرزهما تقول له بتأكيد ويقين كبيرين: "جسدانا يعرف أحدهما الآخر، عصباً عصباً
وخلية خلية"
وفي هذا دلالة على وحدة الجسدين التي
لا تقبل الفصل أو الـتأويل. إنها الحقيقة الواحدة لكليهما أعني للشخصية الأم الولود
والشخصية المتوالدة عنها ولكن قبل أن نثبت هذه الحقيقة علينا أن نتبيّن ملابساتها
لنعرف ما إذا كانت حقيقة فعلاً فهي تقول بعد ذلك بقليل مشيرة إلى: "ذلك الرجل حامل
الرشاش أطلق عليك الرصاص قبل ليلتين، منذ ذلك الحين وأنت تحت تأثير المخدر، كان يجب
أن نجري لك عملية". بنباهة أشرنا إلى أداة الحث ولكننا أجلنا تسميتها تحديداً حتى
هذه اللحظة. إنها (المخدر) الذي يعتمد طبياً لإيقاف فاعلية الدماغ، وفاعلية الجسد،
وشعوره الهائل بالألم. السؤال الآن: كيف تسنّى للشخصية المستولدة أن تكون شاهدة على
ما حدث، وعارفة بتفاصيله إن لم تكن ذاتاً مستقلة لا شأن لها بمن تولدت عنه أو منه؟
ومن هي إن لم تكن قرينه الأنثوي؟ وتأـتي الاجابة منها بشكل مباشر: "أنا قرينتك/
"أنا صديقتك وطبيبتك" وتستمر لعبة القرين بذات الفنية والروحية التي وضع أسسها،
وخطط لها الكاتب بمهارة واتقان فالآخر الذي يحمل الرشاشة أو القيثارة والذي بدأ فعل
القصة قبل أن تبدأ أحداثها قد يكون التوأم الشقيق، وهذا ما تدعيه المرأة، وحتى سائق
الاسعاف فانه الآخر لا يقع إلا ضمن القرناء الذين ابتكرت وجودهم الذاكرة المشوشة
المضطربة للشخصية الأم بِحَثٍّ من المخدر في لحظة زمنية خاطفة خلال مرور الحثّ إلى
الذاكرة قاطعة المسافة بين الباب وبين الدار (الدهليز) وخلال محاولة الشخصية الهرب
إلى الخارج: "أركض في ممر طويل نصف مضاء" ركضاً افتراضياً يعلو على الواقع بطريقة
حلميّة لا يكاد أن ينتهي منه حتى يبدأ ممر آخر وآخر. إنها دهاليز الذاكرة التي
انطلقت باتجاهات مختلفة لا حدود لها، ولا مقود في طيرانها نحو أي من أهدافها الخفية
وغير المعلنة. ومع أنه يصل إلى أبعد من توقعاته غير المحددة فانه يعاود الانفلاق أو
التوالد لينجب هذه المرة طفلاً صغيراً جاء من أعماق ذاكرته ليكون قرينه الجديد
المعمّد ببراءة لا نظير لها في حياته وكما الرجل حامل الرشاش أو القيثار، وكما
المرأة التي انشطرت كجزء انثوي منه فان لهذا الطفل قصة منفصلة عن قصتيهما، ومتصلة
بهما في آن واحد ولها دهاليزها المنفصلة والمتصلة والمعتمة أيضاً. إن مجموعة القصص،
لهؤلاء الثلاثة وللشخصية التوالدية، تشكّل العالم الواقعي والافتراضي في آن واحد
نجح الكاتب في توليفه نجاحاً كبيراً. ولمن لا يعرف فان سعداً كان قد مرّ بتجربة
القرين في إحدى قصصه السابقة ولكن ليس بهذا الشكل التوالدي الذي لا حدود لتوالديته.
هذه
القصص جميعا تنتهي بدخول ثلاثة شبّان ملثمين يخرجون المرأة من الغرفة ويطلقون النار
بكثافة على الشخصية المستوحدة. عند هذه النقطة الحرجة نكتشف السرّ الذي يقف وراء كل
هذه العذابات والارهاصات. إنها الحرب التدميرية التي مرت بها الشخصية ذات حرب
وخلّفت في نفسها كهوفاً معتمة من المخاوف والأمنيات القتيلة. هذه الحرب تنتمي إلى
القوى الضاغطة غير المعنية بما يحدث ما دام بعيد الأثر عنها كقوة متحكمة بمصائر
الشخوص، وكان من نتائجها بدء الشعور شبه الجمعي بالانفصام الشوزفريني، وهذا هو
السبب الذي وقف وراء لجوء الكتّاب في مرحلة ما بعد الحرب إلى استخدام القرائن،
والتوائم والأشباه لبيان فداحة ما وصل إليه الإنسان وقتذاك على الصعيد الاجتماعي
العام وعلى صعيد القوة الضاغطة التي بدأت هي الأخرى عملية البحث عن الشبيه الذي يحل
محلها ويقي شخصها من الأخطار الجسيمة أو المميتة.
في
مقطع صغير لا يتجاوز نصف الصفحة يضع سعد نهاية لقصته (الهرب من الدهاليز القديمة)
عن طريق الولوج إلى الدهليز الأخير الذي يرى فيه متأملاً آخره (قرينه) الممدّد على
الأرض وهو ينزف دماً. وبطريقة فيها من القداسة قدر ما فيها من المثيولوجيا، ومثل
فارس غامض قدم بعد موته بقليل ليحمل جسداً مُسَجّىً هو جسده، تحمل الشخصية نفسها
بنفسها مغادرة إلى الضفة الأخرى بحزن وبكاء:
"أنحني
عليه.. أمرر يداً تحت فخذيه ويداً تحت ظهره وأحمله.. يا الله، كم هو خفيف؟ أيعقل أن
يكون فقد معظم وزنه بهذه السرعة؟ يخيل لي أنْ لا وزن له.. يفتح عينيه يرمقني بنظرة
صافية وأنا أسير به.. يغلقهما.. يريح رأسه على كتفي، دمه يبللني.. وأبقى أمشي.
أحسّني حاملاً موتي، ثم أبكي"
مما
تقدم نستنتج الآتي:
1.حققت
العنونة قدراً كبيراً من مهمة الدخول السليم إلى عوالم القصة وفضاءاتها باختيار
الكاتب للمفردات ذات الدلالة الموحية والمرتبطة بجوهر قصته.
2.اشتغل
الكاتب على مبدأ القرين التوالدي الذي اتسعت به رقعة القصة بما يؤهلها لاستيعاب
الأحداث الواقعية والافتراضية.
3.اشتغل
على الاستهامية، والتداعي الحر ليخلق صورا مدهشة لشخصيته المستوحدة التي تركها
لترسل لنا شفراتها عبر سرد انجرافي.
4.استخدم
نظام الحث فيزيائياً ليسمح للذكرة بالطواف داخل دهاليزها بمرونة عالية.
5.استعار
من المثيولوجيا نهاية لقصته ليحقق قدراً أكبر من القبول بالانفصام الجسدي والروحي
لشخصيته المركزية.
6.قلل
من شأن الحرب ونتائجها ولم يمر عليها إلا مروراً سريعاً وخاطفاً ولو فعل العكس
لاكتسبت القصة دلالة جمالية أكثر من المتحقق فعلياً.
7.القصة
كتبت بطريقة الفايل المضغوط (الكترونيا) لأنها تنفتح على فضاءات واسعة فسيحة مدخرة
المزيد مما لم يقله الكاتب بشكل مباشر على الورق وترك موحياته لتدل عليه بشكل أو
بآخر.
8.تتحلى
القصة بمرونة هائلة منحتها القدرة الكبيرة على التحوّل من شكلها القصصي إلى أشكال
تعبيرية أخرى كالرواية، والمونودراما، والمسرحية الصامتة، والدراما السينمية.
ثمة
كلمة لا بد من قولها في خاتمة المطاف هي أن هذه القصة لا تنغلق على موضوعة واحدة
تناولناها حسب، بل إنها تنفتح على عدد من المواضيع التي لم يتسن لنا الخوض فيها ضمن
هذه المقالة المختصرة، وتركنا لغيرنا من النقاد والمهتمين بقصص وروايات سعد محمد
رحيم أمر البحث في جوانبها المختلفة.
في
جريدة العالم 21/ 4/ 2015