

الحداثة والطليعية والتأصيل في المسرح - قراءة في كتاب لصباح الأنباري
صالح الرزوق
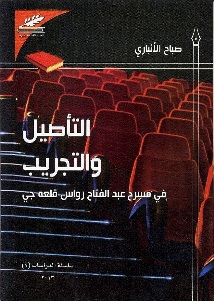

في كتابه (التأصيل والتجريب) الصادر مؤخرا عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق يبدو صباح
الأنباري مهموما بنفس الإشكال الأساسي الذي شغل شيوخ التنوير والنهضة، وأشير بذلك
لأولوية الصعود على متن القطار السريع للحداثة دون التفريط بمقومات شخصيتنا. وأعتقد
أن وراء هذه الدعوة نوع من الكبت السياسي الذي فرضته ظروف الإمبراطورية العثمانية
المزرية. فقد كان الخوف هو وراء فكرة المحافظة على الجذور والرعب هو وراء فكرة
التحديث. كان شيوخ النهضة خائفين من أن يفوتهم القطار (وهذا هو طرف الصراع الأول -
الرغبة بالحياة والتحديث) وخائفين أيضا من التاريخ القهري والظلامي ومن عواقب
الانقطاع في تيار المعرفة النظامية (وهو طرف الصراع الثاني- الرغبة بالحياة
والاحتفاظ بخط للعودة). ولذلك يمكن أن نضع مجمل التاريخ الرسمي للمسرح العربي تحت
مظلة المأساة.
وعليه أرى أن اتهام المسرح في المغرب بالتحديث إلى درجة تشبه الانهيار العصبي،
واتهام المسرح في بلاد الشام بأنه يسير في ركاب السياسة والإيديولوجيا
إلى درجة تشبه البروباغاندا عبارة عن فكرة مجحفة.
لقد انشغل المسرح العربي عموما بالتجديد وفي نفس الوقت لم يتورط بالشعارات. إلا إذا
وضعنا في الحسبان المسرح الترفيهي التجاري المشكوك بقيمته الفنية أو المسرح الذي
وظفه النظام بلا دراية كافية بأصول الفن حتى تحول إلى ما يشبه البيانات والأخبار
كما هو حال المسرح المدرسي الذي له غاية تربوية وحسب اسقاطات مسبقة.
مجمل القول إن المسرح العربي قد بدأ من نقطة النهاية. من لحظة المواجهة المخيفة مع
المصير الغامض والمتعثر. ولا غرابة في ذلك باعتبار أنه نشأ في ظروف تخلف وثورة وبحث
عن طريق مع العناية بتوضيح حالته الطارئة في الوجود. وهي حالة ارتداد ونكوص
واستهلاك للذكريات والماضي. وأرى أن هذا ينطبق تماما على الأستاذ عبدالفتاح رواس
قلعجي موضوع الكتاب. لقد اختار في معظم أعماله شخصيات صنفها الدكتور عبدالرحمن بدوي
في زمرة الشخصيات الاسلامية القلقة. فهو في حوالي عشرة نصوص لم يبتعد عن إطار
التصوف وأئمته أو القادة العسكريين الذين يمثلون إشكالية تاريخية. وكلنا يعلم ماذا
يعني التصوف سواء في حاضره أو ماضيه، فهو تجربة شخصية ذات بعد اجتماع سياسي له
منظور روحي لفكرة التطور. ومثله الذهنية العسكرية التي حاربت للتبشير برسالة تؤمن
بنظرية الدولة. لقد كان الصراع في الحالتين يدور ضمن حدود تجربة ذات، وبشيء من
التوضيح إنه صراع داخلي ضمن ذات الفرد الذي ينتمي لنفسه. و النفس هنا لها بعد خاص
متفرد داخل حدود العصاب الجماعي للبيئة الإسلامية المنتجة.
لقد كتب القلعجي عن النسيمي والسهروردي وخير الدين الأسدي من جهة وعن تيمورلنك
والحجاج من جهة ثانية. وهؤلاء جميعا هم خير من يمثل ديالكتيك القطيعة والرابطة
المعرفية مع شروط القوة (أو خطاب النظام إن شئت التوضيح)، و لكن من ضمن إطار البنية
العالمة للمعرفة. وبعبارة أخرى إنهم الرموز التي حملت هم المحافظة على المكونات
ولكنها كانت متأثرة بالدوافع وضرورة الحركة.
و هذه هي أطروحة الكتاب العامة التي استطاع صباح الأنباري أن يقرأ ألغاز مكوناتها.
يتألف الكتاب من أربعة فصول تناولت موضوع السيرة الافتراضية لذات الفنان، والتأصيل،
والتجريب، ثم الخطاب المعرفي للشكل في المسرح.
وبشكل عام يمكن أن نفهم من مجمل الفصول أن صباح الأنباري يتعامل مع الحداثة والأصول
وكأنهما جدلية الصورة والفكرة، و كلاهما في حالة حركة ونشاط في النص الذي كتبه
القلعجي. ولذلك إن هذه التجربة الخاصة في المسرح كانت تقترب من طرفي معادلة الخيال
الفني وليس الدراما فقط.. لأنها اهتمت بتحديث الأصول وتأصيل الحداثة.
و لكن خلال تقليب صفحات الكتاب والتي بلغت مائة صفحة يخطر للذهن السؤال التالي:
هل إن التجريب هو التعبير المشروع عن الرغبة بالتحديث أو تجاوز السكون والدخول في
نوع متحرك وغير محدود من أصول الكتابة المسرحية؟..
لقد كانت كتابات الغيطاني هي الأقرب لهذا المعنى.. أقصد توظيف رموز من التراث لنقل
أفكار لها علاقة بأزماتنا المعاصرة، كما فعل في الزيني بركات التي تحدث فيها عن
القمع والتعذيب والدسائس والصراعات الجانبية على حساب تطوير المجتمع ورفاهيته.
و لئن كان القلعجي قد فعل ذلك في عدة مسرحيات يجب أن ننتبه إلى أنه كان يدور ضمن
المعنى المعاصر لفن الدراما، ببنيته وحساسياته. ولم يذهب لأبعد من ذلك مثل الغيطاني
الذي وظف الكتابة الديوانية وكل أنواع البلاغة التي تركت علاماتها الفارقة طوال
فترة الانحطاط.
لا تجد في مسرح القلعجي ظاهرة تدارك اللفظ في إطار التراكيب. وأقصد بذلك السجع
والاستعارات القريبة المحسوسة والصور التي لها رصيد مادي في حياة العامة والنخبة.
ولذلك أعتقد أنه كان أقرب ما يكون للتجريب و أبعد ما يكون عن التحديث. و لنتوصل إلى
اتفاق حول مسألة التصنيف والمصطلحات يمكن أن نقول إنه كان طليعيا. ويتعامل مع
الدراما من منظور ذاتي وليس على خلفيات خطاب له من العمر ألوف السنوات.
و هذا ينطبق أيضا على قراءة الأنباري لمسرحية الفصل الأخير والتي يرى أنها محاكاة
فنية لسيرة الكاتب نفسه. وأنها في الأعماق تفكيك للتركيب الطبقي للمجتمع. وبهذا
المعنى يقول: لقد لفت أنظارنا بطريقة ذكية لواقع التناقض الطبقي. ثم يضيف في مكان
آخر: إنه عكس من خلال التناقض الطبقي التفاوت بين فئات المجتمع الحلبي وربما
المجتمع العربي.
لقد كان القلعجي في هذا النص قريبا من الحالة العامة للشخصيات الإسلامية القلقة.
فهو مثل بطل مسرحيته متعدد النشاطات ويكتب في كل الفنون الأدبية. وهو مثل بطل
مسرحيته أيضا لا يعرف لمن ينتمي للخطاب أم لأدوات الخطاب، للإيديولوجيا أم للدولة.
ولذلك أستبعد أنه كان يحلل مشكلة الطبقات في المجتمع. إن هذه العمومية في رسم
الشخصيات تضع مسافة تفصل الكاتب عن ذاته وعن البنية التحتية للذهن الاجتماعي.
لقد اهتم القلعجي في كل مسرحياته بالتفسير فوق التاريخي. والواقع لديه عبارة عن
محاكاة طبيعية للذهن. بمعنى أن كتاباته هي إعادة إنتاج لما يدور في الذهن من أفكار.
وكلنا يعلم ماذا قال الجاحظ أبو عثمان عن ذلك.. الأفكار موجودة على قارعة الطريق
والصياغة هي المعول عليها.
و بالتالي إن الفرضية التي وردت في الكتاب عن استلهام القلعجي لجزء غير يسير من
مادته من التراث ( والمادة هنا هي الأسماء والملابس والوقائع ) لا تحول النص
المسرحي المعاصر إلى نص في رأسه بذرة التراث. إنها عبارة عن استعارة تعكس ارتباطات
القلعجي الوجدانية وجوه الفكري. إن لم نقل ارتباطاته مع الأطروحة المعاكسة للمطدرس
التي كانت تنشط في سوريا وفي المقدمة الواقعية الطليعية، و قبلها الواقعية
الإشتراكية وفق نمط ستانيسلافسكي أو بريخت.
وفي أفضل تقدير يمكن أن نرى أن شخصياته المأزومة هي انعكاس للقلق الإيديولوجي الذي
يضطره للابتعاد عن العناصر ومكونات الواقع. وللاختباء بمرحلة تالية خلف أدوات
النخبة كالطرب والتاريخ والتنظير وهلم جرا، كما تفضل ولاحظ الأنباري في كتابه.
لقد صنعت النخبة المحافظة في سوريا بين الخمسينات وحتى بوادر الألفية الثالثة ما
يشبه الكونتون، والذي ترادف بمضمونه و شكله مع غيتو ذهاني معارض. و قد كان يستمد
هذا الغيتو ذخيرته من التراث ( ليلغي الاتجاهات الواقعية المادية ) ومن البيئة
المحلية ( ليضرب بها الشعار اليساري المدعوم من ذهن أممي أو قومي اجتماعي). ولم يكن
القلعجي بعيدا عن هذه التوجهات وإن لم يكن رمزا من رموزها. وهذا يفسر لماذا كان
ممنوعا من الكتابة ولماذا هرب بقلمه ومخطوطاته من سوريا إلى بيئة حاضنة في بيروت (
كما ذكر الأنباري في مستهل الكتاب وبحروف عريضة وواضحة).
عموما، و بلغة النقد الفني لم تكن مسرحيات القلعجي تراثية، و لكنها ضمن حركة مختصة
بإحياء جزئيات من التراث، كما أنها اعتراف من الكاتب بموقفه المتعاطف مع الماضي ومع
المخزون التاريخي لما نسميه عادة بالإسلام العربي. لا شك هناك فارق ملحوظ بين
الإسلام السياسي وتمجيد الإسلام بنسخته العربية. إنه نفس الفرق الذي تعكسه مسرحيات
علي أحمد باكثير بالمقارنة مع مسرح عبدالرحمن الشرقاوي. والقلعجي يأخذ مكانا
بينهما. بين العقدة التي تعتقد أن الاسلام هو الحل والعقدة التي تحاول احتواء
الإسلام وهضمه و ابتلاعه.
وعليه أرى أن القلعجي مثل أبطال مسرحياته لا يعرف كيف يندمج بواحد من الطرفين، وهو
غالبا ما يهرب في اللحظة الحاسمة من المواجهة. ويفضل أن يعيش مأساته الخاصة في بلاط
كالحجاج أو في وجد روحي وفناء إيماني كالسهروردي. وهذا هو مكان تشكل الدراما لديه.
إنها لحظة رفع الستار عن المسرحية التي يعيشها بأبعادها المؤلمة، وأقصد بذلك نار
الشك بالذات وصعوبة التوصل لقرار أو نتيجة. ولذلك يمكن أن نقول إن مسرحياته مغلقة.
إنها مسرحيات دائرية تؤمن بمعنى البداية والنهاية. بعكس مسرح وليد خلاصي أو سعد
الله ونوس الذي يتحرك ضمن مربع له حدود واضحة.
ولذلك إن المكونات الاجتماعية في مسرح القلعجي هي عبارة عن استطراد لذهن مسبق.
وليست ناجمة عن حركة المجتمع. ويمكن أن تجد أبعادها الرؤيوية في محاكاة دون كيخوتة
لقصص المغامرات التاريخية.
ويؤكد على ذلك طبيعة الرموز الخلابة التي يستعيرها من بطون الكتب. إنها رموز معرفية
بعيدة عن الاحتراق بنار التجربة. فهو لم يعاصر الحجاج ولم يعايش السهروردي. ولم تكن
لديه صلة بالمجتمعات المنتجة لهما. حتى أن البنية الفنية متباعدة عن معنى الشرط
الموضوعي. فهي خارج نسق الكتابة وخارج حدود الذهن الفني. ولن تجد أثرا لسطر واحد له
شكل كتابة الدواوين و المقامات، والتكنيك يوظف أدوات حديثة تجد مثلها في المسرح
الأوروبي.
وحتى بالنسبة لمسرحية الفصل الأخير إن الكاتب وقرينه هما أقرب لحالة رواية ( هذيان
) في العمل المعروف لأنطونيو تابوكي والتي يتكلم فيها عن لحظات النزع الأخير لرائد
الشعر الرومنسي في إسبانيا ( فرناندو بيسوا ).
ولئن ليس في ذلك ما يعيب فهو تعبير كما ذكر الأنباري عن الاشمئزاز من السقوط
الاجتماعي للسلوك المعاصر الذي يعاني من الجدب و اليبوس ومن قلة الإيمان بالمبادئ.
وبالتالي من لا جدوى الواقع نفسه.
و كانت وسيلة القلعجي للالتفاف حول هذا الواقع العقيم والمرفوض اللجوء للأدوات
والصور الشعبية. مثل الحكواتي والقرة قوز وخيال الظل وصندوق الدنيا ( وقد لاحظ
الأنباري ذلك في معرض حديثه عن مسرحية سيد الوقت). ولنضع تحت هذه العبارة خطا أحمر.
لقد كان القلعجي يعيد أصولا بناء ذاكرتنا الشعبية وليس ذاكرتنا التاريخية ذات البعد
النخبوي.
و هنا أرى أنني مضطر للتعليق.
كانت اختياراته عاطفية ولها بعد محلي. فخطاب القلعجي لم يغادر مدينة حلب. إنه في
الموسيقا تخصص بالأوبري. وفي التصوف استطرد مع الشيخ العلامة الأسدي مؤلف موسوعة
حلب المقارنة. و في فن العمارة و تخطيط المدن تكلم عن أحياء و أسواق حلب. و خص
بالذكر الشعبية منها.
ولذلك أرى أن مرجعيته لم تكن للتاريخ السياسي عند العرب ولا للتجربة الروحية
للمتصوفة. وإنما للبنية النفس اجتماعية للطبقات دون المتوسطة أو عامة الشعب التي
تتأثر وجدانيا بصور ومكونات ميتة: منها عبر ودروس التاريخ المنصرم. ومنها شخصيات
مشتركة وبسيطة تتحلى بالكرامات والمعجزات التي تعتبر من الأسانيد القوية للشخصيات
المريضة والضعيفة نفسيا وثقافيا. أضف لذلك الإطار الوجداني الجامع للإسلام، ليس
لأنه دين أو فقه ولكن لأنه يحتفظ من الماضي بصورة ذهبية تغذي إحساسنا المفقود
بالكرامة وعزة النفس.
ختاما لقد كان صباح الأنباري في كتابه، كما عهدناه دائما، يتكلم قليلا في الأمور
النظرية و يستغرق كل الوقت في التطبيقات من تفسير و تأويل و تفكيك. لقد ركز
الأنباري اهتمامه في كتابه على ثلاث نقاط:
1- قراءة المنصوص عنه، أو تأويل مسرحيات بعينها.
2- دور المخرج بالانطلاق من توجيهات الكاتب. و قد كان مروره سريعا على هذه الناحية
الهامة و الإبداعية التي تشبه ما نفعله في تحويل نص روائي إلى مسرحي. فالإخراج مهم
مثل الكلمات المكتوبة لأنه رؤية قبل أن يكون ترجمة حرفية.
3- لم يعمد للمقارنة و كأن عبدالفتاح قلعجي ظاهرة تعمل بمفردها في ميدان فن المسرح.
والذكر الخاطف لوليد إخلاصي و فرحان بلبل لا يشفي غليل أحد. وهذا ديدنه دائما. ففي
دراساته عن بيكة سي و زنكنة لم يربط الحساسية الخاصة بالجو الإنساني العام. و قل
نفس الشيء عن الصور والمعاني المشتركة التي دخلت في الفضاء العام للذهن. من ذلك
العرافة وعقوبة الصلب. لم يحاول الأنباري أن يربط أيا منهما بالبروتوتايب الخاص
كمفهوم شكسبير للعرافة والتفسير المسيحي للإعدام على الصليب. و ينسحب ذلك على
الخلفيات التي تعمل من وراء الكاتب. فهو لم يفسر معنى إلحاح القلعجي على الشخصيات
التاريخية. هل إن دوافعه مثل دوافع علي الطنطاوي مؤلف شخصيات من التاريخ؟.. وكذلك
لم يفسر اهتمامه بمدينة حلب كعاصمة لشمال سوريا ودورها المنافس على تحديد مصير هذا
البلد.
إن هذه المسألة المنهجية التي هي في صلب بناء الخيال الفني وموجهاته وموجباته قد
تجاوزها الأنباري، و كأنه أراد أن يكون من طرف نظرية ( موت المؤلف ) و ( موت النص)،
لو لا النذر اليسير من الإشارات في المقدمة. و لم تخرج على هذه القاعدة الذهبية غير
مشكلة ( الرقابة ) وما توحي به من عقاب وقسوة غاشمة. لقد تجاوز الأنباري كلما اقترب
من فرضية فوكو عن الرقابة والعقاب حدود المربع الافتراضي للخطاب، ودخل في تحليلات
وتعليقات تعكس تحربته الشخصية وجزءا من ماضيه أو ذاته. لقد كسر الأنباري أولوية
الموضوع على الذات في هذا المجال فقط.
4 - و لكن يدعم اهتماماته بالموضوع قراءة العناوين قراءة سيميائية، و قد أضفى ذلك
على الكتاب خطا يفترض أنه محايد. بحيث لا يعلو صوت ورأي الناقد على صوت ومفهومات
الكاتب. لقد كان الأنباري يقرأ المسرحيات بالشكل المعروف للنقد الفني. إنه يهتم
بالموضوع ومعنى التراكيب والشخصيات ثم بالمفردات التي قد تكون مدخلا شرعيا للنص. و
يبدو أن منهج صباح الأنباري هو هو في معظم دراساته، سواء عن الشعر أو الرواية أو
المسرح. إنه يعول كثيرا على اللفظ ويعود بك مرارا وتكرارا للمعاجم ولجذر المفردات
واشتقاقاتها. وهذا يضعه في دائرة الامتنان للأجداد، و لما تركوه لنا من تقاليد
وقوانين بذل الغالي والرخيص في سبيل الدفاع عنها.
كانون الأول 2013